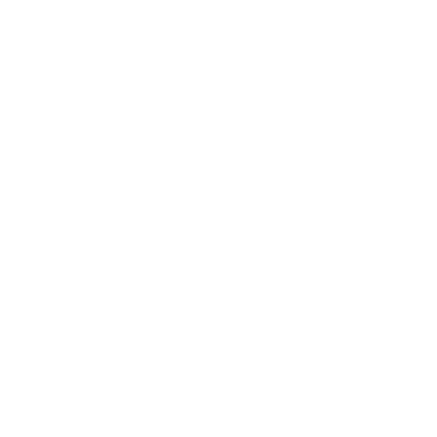في فيلمه الوثائقي “آخر الكلام” (2014)، يقترب المخرج الجزائري المقيمُ في فرنسا، محمّد الزاوي، مِن الروائيّ الراحل الطّاهر وطار (1936 – 2010) خلال سنواته الأخيرة.
قبل رحيله بشهرين، قضى صاحبُ “الشهداء يعودون هذا الأسبوع” أيّاماً في ضيافة المخرج بمنزله في قرية مونفرماي بضواحي باريس خلال فترة تلقّيه العلاج في فرنسا بين 2009 و2010، وفتح له قلبه، مُطلقاً العنان لسيل من الأحاديث والذكريات… لحظاتٌ وثّقتها كاميرا الزاوي في فيلمٍ ينقل بلغةٍ شاعرية وحميمية صورةً قريبةً عن وطّار الإنسان والكاتب معاً.
في هذا الحوار، الذي خصّ به موقع التلفزيون الجزائري، يتحدّث محمد الزاوي عن تجربة الفيلم الذي يُعرض اليوم على القناة الأرضية للتلفزيون الجزائري، تزامناً والذكرى الرابعة والثمانين لميلاد صاحب “الشمعة والدهاليز”.
■ حدِّثنا أوّلاً عن علاقتك بصاحب “اللاز”، هل تعرّفت إليه خلال تلقيّه العلاج في باريس حيث تُقيم، أم أنَّ علاقتك به تعود إلى أبعد مِن ذلك؟
– أعرف الطاهر وطّار منذ كنتُ في السابعة عشرة. في هذا العمر، كُنت رئيس فرقة مسرحية بالمدية، ووقتها اقتبستُ روايته “الزلزال” لخشبة المسرح. كان أيضاً أوّل روائي أقرأ له بعد الكاتب المصري طه حسين. وحين كنتُ صحافياً في جريدة “الخبر”، أجريتُ العديد من المقابلات الصحافية معه.
وخلال تواجده بمستشفى سان أنطوان بباريس، كان من الطبيعي أن أزوره باستمرار وأساعده في قضاء بعض الحاجيات التي لم يكُن يستطيع قضاءها بنفسه؛ فقد كان مُقعداً ومريضاً.
كنّا نعوده بشكل مستمر في مجموعةٍ تضمُّ أيضاً الصديق عمار مرياش والطيّب لعروسي وواسيني الأعرج، وقد استمرّ ذلك لمدّة سنة، حتّى قدّم له الطبيب وصفةً طبية وطلب منه أن يدخل بيتَه. لا أدري ماذا جرى مِن حديث بين الطبيب ووطّار. أذكُر أنه كان مُتعباً، فطلبتُ منه أن يبقى معنا في البيت، ووعدته بمرافقته بعد أسبوع أو عشرة أيام فقبل اقتراحي.
■ هل خطّطتَ لإنجاز فيلمٍ وثائقي عنه، أم أنَّ كلّ شيء حدث بشكل عفوي؟
– أثناء وجوده في البيت، حملتُ ذات يوم كاميرتي الصغيرة بعدما استرسل في الغناء. كان يغنّي بالشاوية وبالعربية أغاني من التراث الجزائري لمغنّين كبار مثل عيسى الجرموني. كان مستلقياً على الأريكة ويغنّي، فقلتُ له: “عمّي الطاهر، هل يمكن أن أصوّر وأنت تغنّي؟ إنها لحظة جميلة”، فقال لي: “ماذا تنتظر؟ بإمكانك أن تُصوّر”.

وضعتُ الميكروفون بشكلٍ لا أحرجه فيه، ووضعتُ نفسي في زاويةٍ وبدأتُ بالتصوير دون أن أتحرّك يميناً أو شمالاً، ثم بدأ يحكي لي عن طفولته. أتذكّر أنَّ عينيه كانتا تنظران إلى السماء وهو يستحضر ذلك الوقت الجميل في طفولته.
طوال تلك الأيام، كنتُ أحاول أن ألتقط له يومياته العادية أثناء وجوده في البيت؛ فمثلاً تزامن ذلك مع نهائيات كأس العالم وكنّا نشاهد المباريات سويةً، وكان وطّار يتابعها بحماس. وحين يستلقي عل الأريكة، كان يحكي لي عن تلك الورقة البيضاء الوحيدة في بيت جدّه وعن مصحف القرآن الوحيد الذي كان يحتفظ به شيخ القرآن الذي كان عند جده، وعن خاله الذي كان يمزّق حذاءه من ضربات رجلَيه وركبته القوية على الأرض وهو يرقص في الأعراس وقد ترك له والده ثروة بذّرها كلّها، وعن تلك القيثارة (السنيترا) التي جاء بها من قسنطينة إلى امداوروش وسُرقت منه فبكى لأنه لم يجدها، وعن والده الذي كان ينتظر من ابنه أن يعود إماماً يُصلّي بالناس.
■ تبدو ثنائية الهوية/ الذاكرة الأكثر حضوراً في المشاهد المتعلّقة بالطاهر وطّار… كيف كان صاحب “الشهداء هذا الأسبوع” يُقارب هذه المسألة، وكيف جعلتَ منها ثيمة أساسية في الفيلم؟
– أعتقد أن وطّار يجيب بشكل وافٍ عن سؤال من نحن؟ عن أسئلة الهوية والذاكرة؛ فهو يعود بنا إلى هويتنا الحقيقية. والحقيقة أنّ وطّار يعود بذاكرته إلى طفولته التي يتحدّث عنها بطريقة سحرية غريبة لا تسمعها إلّا عند كبار كتّاب الرواية في هذا العالم.
في البداية، كان هناك خيطٌ درامي يقودني، وهو هذا الصراع بين البقاء في الحياة وبين الموت القادم. هذا الجوُّ الدرامي الذي يعود بالذاكرة إلى الماضي؛ فوطّار الذي لم يزُر مداوروش، مسقط رأسه ومرتع طفولته، زارها من خلال هذا الفيلم. كان يحكي ويتذكّر تفاصيل ويستعيد وجوهاً من ذاكرته البعيدة.

هناك أيضا حديث طويل عن تجربة الكتابة وطقوسها، فهو لا يكتب إلّا بانفجار بركاني داخلي.
طعّمتُ ما كان يقوله بمشاهد مِن مسرح الظل أدّاها الممثّل الجزائري المقيم في هولندا، حكيم طرايدية، الذي أعاد تمثيل الكاتب في مشاهد إيحائية. ثمّة أيضاً لوحاتٌ للكاتب وهو بعصاه السحرية التي أحبّتها ابنتي ياسمين. وهذه كانت الشخصية العفوية والتلقائية في الفيلم. كان ثمّة ألفةٌ كبيرة بينها وبين عمّي الطاهر، وأعتقد أنه كان يتذكّر من خلالها ابنته سليمة وحفيده.
وبمرافقة الفنانة التشكيلية الجزائرية إيمان مباركي، التي كان الراحل قد رعاها وساعدها على تنمية موهبتها في الفن التشكيلي في “الجاحظية”، تنقّلنا إلى امداوروش وكان معنا الصديق المصوّر فاتح الذي ساعدني في النقل والتصوير، وقد أرفقتُ هذه الرحلة البصرية بموسيقى تمنح طُعماً خاصّاً للمتلقّي وتترك له أثراً مميّزاً، وتضعه في حالة قابلة للتخيّل والمشاركة، مثلما يتخلّل الفيلم تدخُّلات لنساء ورجال تعاملوا مع نصوصه عبر آليات نقدية وجمالية من بينهم الراحل جمال الغيطاني وواسيني الأعرج ومحمد ساري ومخلوف عامر وسعيد بوطاجين.
هناك، أيضاً، مقرّبون يتكلّمون عن الجوانب الهامة في شخصية الروائي والإنسان الطاهر وطّار ويثيرون ذكريات من مواقفه حول قضايا فكرية وسياسية والجدل الذي أثاره حولها مثل قضيتي الهوية واللغة وغيرهما.
■ اقتصرت مشاهد الطاهر وطّار في فيلمك الوثائقي على البيت، هل كان ذلك خياراً أم أنَّ ظروف التصوير فرضته؟
– صحيح؛ كان صالون البيت وحديقتُه الفضاءَين اللذين صوّرتُ وطّار فيهما. لم أصوره في باريس لأننا لم نسافر إليها؛ فهو لم يكن في نزهةٍ بل جاء للعلاج.
■ قدّمتَ عملت توثيقياً، لكنَّ الجانب الحميميّ يحضر بشكل واضح في الفيلم. كيف وفّقت بين الجانبَين؟
– لقد حاولتُ أن يكون الفيلمُ مختلفاً عن الأفلام المعتادة عن الكتّاب؛ حيث تبنّيتُ لغةً بصرية جديدة وغير مألوفة في المشهد التلفزيوني وفي علاقة الكاميرا بالكتّاب، لأنّ كل اللقطات التي التقطتها هي مشاهد قوية بحيث أنها توثّق للحظة إنسانية لا يمكن استعادتها أو تصويرها من جديد؛ فهي لحظات فيها الكثير من التلقائية العجيبة في طريقة سرد الكاتب لمساره، بما يحمله خطابه من إنسانية وعمق وقوّة انفعالية وعاطفية سيتفاعل معها المشاهد، الأَمر الذي يُعطي لهذا العمل مشروعيته؛ بحيث يُصبح الفيلم وثيقة سمعيةً بصرية لها كل قوّتها، وهذا لأن الراحل نجح في خلق نوع من الحميمية مع المتلقّي وهو يحكي حكايات غريبة غير مألوفة وخارقة في حياته عبر السنين.
لقد ابتعدتُ، بطريقة واعية، عن التصوير بالطريقة النمطية المتعارَف عليها في تسجيل الكتّاب، بالتقاطي مشاهد للراحل وهو جالس، وقد ساعد الضوء القادم من النافذة في توفير إضاءة حميمية. لم أغيّر زاوية الرؤية إلّا في بعض اللقطات، بحيث كنت أسجّل لقطات قريبةً جدّاً، حينما كان الراحل متأثّراً بما يحكيه، ولأُعطي تعبيرات الملامح قوّة أكبر، وفي الوقت ذاته فقد كنتُ أصوّر من حين إلى آخر محيط الطاهر وطار؛ مثل الريف الفرنسي وحركة الحيوانات الأليفة بالحديقة كالأرانب والدجاج والقطط.
التقطَت الكاميرا، وعلى مدى ساعاتٍ، تلك الصور القريبة التي تعكس ألم الكاتب، ملامح وجهه، تعابيره، وعلاقته بالكلام… فوطّار يجيد التعبير بالملامح، وقد كان على أبواب الوداع، فكان يستحضر كلَّ تلك اللحظات القوية في محطّات حياته.
ركّزتُ على عددٍ قليل من الكادرات في تصوير الطاهر وطّار وهو يحكي متمدّداً على الأريكة، واعتمدتُ أساساً على اللقطات القريبة والقريبة جدّاً والمتوسطة لعكس تعبيرات الوجه والتأثّر. أمّا اللقطات البعيدة فلم أستعملها إلا أحياناً.
هيكلتُ الفيلم على شكل سلسلة من الرحلات التي تنطلق أساساً من كلام الراحل وما يحيط به من أصوات وصمت في آخر أيامه، وتمّ بناء كلّ ذلك على قصّة سيرة ذاتيه متفرّدة؛ حيث تنقلنا هذه السيرة من الريف إلى البحر، إلي أجواء المدينة، وهنا تأخذ الصورة كلّ أبعادها في هذه الرحلة الطويلة التي تعطيها الموسيقى المحلية والتعليق الصوتي وصوت ابنتي ياسمين التي تقرأ بعض نصوصه بالفرنسية وأنا بالعربية، ذوقاً خاصاً.
■ هل من ذكريات أُخرى ترويها لنا عن تلك الفترة التي قضيتَها مع الطاهر وطّار؟
في مونفرماي، القرية التي أُقيم بها في الضاحية الباريسية، ظلّ الطاهر وطّار يحنّ إلى مسقط رأسه، وكان يقوم بمراجعة ذاتية. لقد ثبّتتُ الكاميرا في مكان هادئ وسجّلتُ استماعه بكثيرٍ من الحنين للأغاني البدوية التي كانت تخرج من هاتفه؛ فعلى مدى ساعات كان الراحل يستمع ويغنّي ويحكي مساره الإنساني والإبداعي، وعن الجينات التي اكتسبها من هذا الخال الذي كان يرقص في الأعراس ويمزّق أحذيته بها، أو عن هؤلاء الأطفال الذين كان في بداية شبابه يقص عليهم “كليلة ودمنة” أو “ألف ليلة ولي” حينما يعود في فصل الصيف إلى امداوروش.
■ أنتجت فيلمك عام 2014، وها هو يُبثّ اليوم على شاشة التلفزيون الجزائري بعد قرابة ستّ سنوات على ذلك. ماذا تقول بالمناسبة؟
– نعم، لقد انتظرتُ خمس سنواتٍ لكي يشاهد الجزائريون هذا الفيلم الذي حاز جائزة “النخلة الذهبية” في مهرجان الإسكندرية السينمائي قبل سنوات… حاولتُ ذلك في السابق لكنّني لم أجد آذانا صاغية.

أعتقد أنَّ كثيرين سيغيّرون، بعد مشاهدته، طريقة تفكيرهم ونظرتهم إلى الأشياء، وتحديداً إلى موضوع الهوية، كما أنه يجيب عن سؤال مركزي هو: كيف أصبح الطاهر وطّار روائيّاً كبيراً؟ وهذا سؤال يهمّ كثيراً من الكتّاب الشباب خصوصاً.
فرحتي اليوم كبيرةٌ بعرض الفيلم؛ فالراحل روائيٌّ كبير جدّاً وله مكانة كبيرة في الأدب العربي، وهو شخصية تحظى بالكثير من الاحترام، وتُرجمت أعماله إلى عدد كبير من اللغات.
■ في الأخير، ما هي مشاريعك المستقبلية؟
– لديّ مشروعا فيلمَين وثائقيَّين يدخلان أيضاً ضمن ثيمة الذاكرة؛ الأوّل أستعيد فيه سيرة والدي، وهو رجل دين له تجربة حياتية ثرية واحتكاك بمجتمعه، من خلال رحلة بحث عن حذائه الأبيض، والثاني عن الفنّان الجزائري الكبير عثمان بالي، وهو عملٌ يحتاجُ جهداً توثيقياً كبيراً وتمويلاً أيضاً.